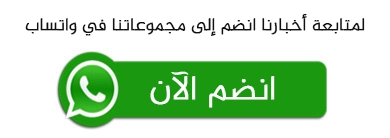حين يُجرَح وطنه ويُطلب منه الصمت دارفور لا تطلب تعاطفًا، ولا تبكي من ضعف. دارفور، ببساطة، تسأل:لماذا يُفرض علينا الموت كحلّ سياسي؟وما الذي يجعل الخرائط تُرسم من فوق دمائنا، ثم يُطلب منا التصفيق للسلام؟
لسنوات طويلة، كانت مأساة دارفور تُقدَّم كصراع قبلي، أو نزاع على موارد. لكن الحقيقة أعمق، وأكثر إيلامًا: إنها حكاية وطن جُرّد من المواطنة، ثم وُصِف تمرده بأنه فتنة.
■ التهميش: السياسات التي مهدت للحرب
منذ الاستقلال، أدارت الحكومات السودانية ظهرها لدارفور. لم تكن هذه مجرد غفلة، بل نهجًا ممنهجًا من الإقصاء، تجلّى في الحرمان من التعليم، البنية التحتية، التوظيف العادل، وحتى التمثيل الرمزي.
ظل المركز ينظر إلى دارفور كمنطقة “بعيدة” جغرافيًا، و”خطرة” سياسيًا، و”هامشية” تنمويًا. وباسم السيادة، تم سحق المطالب العادلة بحياة كريمة. حتى حين حاول أبناء دارفور الدخول من بوابة السياسة، أُغلق الباب، فاختاروا طرقًا أخرى… كان بعضها مؤلمًا.
■ من المطالب إلى البنادق: تحوّل المشروع
عام 2003 لم يكن بداية الصراع، بل لحظة انفجاره. كانت نيران الإحباط قد تراكمت، وأغلقت الدولة أذنيها.
قامت الحركات المسلحة بتدويل الصوت، فجاء الرد من الحكومة بالقصف، والتجنيد، والتحالف مع المليشيات.
دخل “الجنجويد” إلى المشهد، لا كمجرد مليشيا، بل كاستراتيجية دولة. وكانت النتيجة: قرى أُحرقت، وأرواح سُحقت، وتاريخ بأكمله كاد يُمحى.
في تلك اللحظة، لم يكن هناك منتصر. فالجميع خسر: الدولة خَسِرت شرعيتها، والثوار فقدوا بوصلة التغيير، والناس خسروا أمنهم وثقتهم في كل شيء.
■ حين يصبح الإعلام شريكًا في الجريمة
في عالم يُفترض أنه يراقب، تم تجاهل دارفور بإرادة باردة. الإعلام العربي تغافل، وتواطأ أحيانًا، وغاب كثيرًا.
وفي كل مرة حاولت دارفور الصراخ، ردّت عليها الشاشات بالصمت أو الاتهام.
هل كانت دارفور خارج “الهوية العربية” لذلك لم تُنقل مأساتها كما نُقلت غيرها؟
أم أن الضحية لا تُروى قصته ما لم تتقاطع مع مصالح الكبار؟
الأسوأ من الصمت، هو التزوير. حين يتحول القاتل إلى “مدافع عن الأمن”، والمجني عليه إلى “مخرب”، تصبح الكاميرا أداة قتل أخرى.
■ المجتمع الدولي: بين البيانات الباردة وتجارة الأزمات
أصدرت الأمم المتحدة قرارات. فرضت المحكمة الجنائية أوامر اعتقال. عقدت العواصم مؤتمرات.
لكن كم قرية عادت لأهلها؟ كم لاجئ غادر معسكرات النزوح؟ كم طفل نجا من الجوع؟
دارفور كانت قضية مربحة للمنظمات، وورقة ضغط للسياسيين، ومادة للعواطف العابرة في نشرات الأخبار. لكنها لم تكن يومًا أولوية حقيقية.
حتى حين ظهر التفاعل، كان انتقائيًا، سطحيًا، مؤقتًا.
■ ما بعد الثورة: دارفور في قلب الفوضى
اعتقد كثيرون أن سقوط النظام سيعني بداية العدالة لدارفور. لكن الواقع أن الدولة انسحبت، والمليشيات تمددت، والسلاح أصبح أقرب من الطعام.
اتفاق جوبا للسلام لم يكن اتفاقًا على المصير، بل تقاسمًا للمواقع.
والحركات التي كانت تحمل البندقية للحرية، حملتها اليوم لحراسة سلطة فقدت معناها.
النتيجة؟
دارفور الآن خارطة من الانهيارات: أمنية، اجتماعية، إنسانية.
■ أي مستقبل ممكن؟ الطريق إلى العدالة والكرامة
لن تُحل قضية دارفور في المؤتمرات المغلقة، ولا بالمساعدات الطارئة.
الحل يبدأ من الاعتراف بالآتي:
1. أن دارفور لم تتمرد، بل رُفضت في وطنها.
2. أن العدالة لا تعني المصالحة السطحية، بل محاسبة الجناة من كل الأطراف.
3. أن إعادة الإعمار يجب أن تضع الناس في مركز القرار، لا نخبة فوقية.
4. أن الدولة السودانية بحاجة لإعادة تعريف: من سلطة تهيمن إلى عقد اجتماعي يعترف بالجميع.
■ الختام: لا سلام مع النسيان
دارفور لا تحتاج إلى شفقة، بل إلى عدالة، ومشروع، ومصارحة.
إن تجاهل دارفور ليس خطرًا على الإقليم وحده، بل على السودان كله.
فكل وطن يدفن جراحه دون علاج… ينزف في صمت حتى الموت.
المهندس محمد مبارك الصادق ..باحث وكاتب في الشؤون الهندسيه والسياسيه